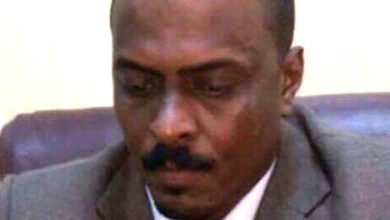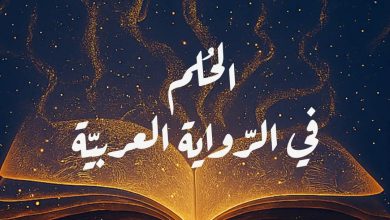مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية: إطلالة على جائزة المقال الإماراتي(جلسة حوارية وقراءة نقدية)

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية:
إطلالة على جائزة المقال الإماراتي
(جلسة حوارية وقراءة نقدية)

بقلم: شاكر نوري
بادرت مؤسسة العويس الثقافية إلى إقامة ندوة مهمة حول “جائزة المقال الإماراتي” في قاعة المحاضرات، شارك فيها كل من الأستاذ علي عبيد الهاملي والدكتورة مريم الهاشمي، وأدار الندوة وطرح أسئلتها جمال الشحي، مع نخبة من المثقفين والكتّاب والمهتمين.
كان السؤال الذي افتُتحت به الندوة موجهاً إلى علي عبيد الهاملي حول نشوء فن المقال الإماراتي حتى الوقت الحاضر. قدم الهاملي نبذة تاريخية عن نشأة الصحافة في الإمارات، قائلاً: “إن المقال الإماراتي مر بمراحل عديدة ورافق نشأة الصحافة إلى أن وصلت إلى الصحافة الحديثة. بدأ الكتّاب الإماراتيون يكتبون المقال منذ ذلك الحين”.

وأشار إلى أن فن المقال بدأ في القرن السابع عشر في فرنسا، ووصل إلى العالم العربي في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من خلال المجلات والصحف مثل “الأهرام” و”المقتطف”، ومن أشهر أعلامه آنذاك طه حسين، والشيخ محمد عبده، وعباس محمود العقاد. وأضاف: “لم تكن حينها لدينا صحافة. لاحظنا أن كتّاب الإمارات بدأوا يكتبون في هذه الصحف والمجلات العربية، أمثال د. أحمد المدني، وأحمد حسن، وسلطان العويس في مجلة (المنار). في هذه الفترة، ظهرت لدينا (صحافة الحائط) في العام 1927، فكانت بداية الصحافة المكتوبة، مثل (صحيفة عمان) التي كانت تُكتب بخط اليد، وتوزع في الفريج. وظهرت منابر مثل (العمود) و(صوت العصافير). لم يكن الوضع يسمح بوجود المطابع آنذاك بسبب الوجود الأجنبي في الخليج. وأول صحيفة كُتبت بالآلة الكاتبة هي (الديار) العمانية في عام 1964”.

هل تشكلت عبر أكثر من خمسين عاماً مساحة للرأي والمقال الفكري؟
أجاب علي عبيد الهاملي: “في كل هذه المرحلة كانت المقالات ذات طابع ديني واجتماعي وأدبي، وليست مقالات حديثة بالمعنى الحالي. قبل قيام الاتحاد، وفي 16 يناير 1965، صدرت (أخبار دبي) وهي تؤرخ لبدايات نشأة الصحافة بشكل دوري. ثم تحولت إلى أسبوعية، وفيها الألوان والتبويب والتوزيع. وجد فيها الكتّاب أنواع الكتابة الصحافية، أمثال عبد الغفار حسين، والشيخ عبد الجبار الماجد، وعبد الحميد أحمد، ومظفر الحاج محمد، وشيخة الناخي، وموزة سالم وغيرهم. كنتُ في عام 1971 أكتب في مجلة (أخبار دبي) التي كانت الوحيدة”.
وتابع: “ومن ثم ظهرت (صوت الخليج)، و(صوت الأمة)، و(الفجر)، بحيث أصبح المجال مفتوحاً أمام الكتّاب، وهي نقلة نوعية في شكل المقالة منذ منتصف الستينات إلى نهاية السبعينات. وأهم مرحلة في تطوّر الصحافة كانت مع ظهور مجلات الأندية، مثل (مجلة الأهلي) 1972، وشاركتُ في تأسيس منابر مثل (النصر) و(الوصل) و(الشباب)، وكان سقف التعبير فيها عالياً ولا حدود له، مثل (مجلة المجمع) و(الأزمنة الحديثة)”.

ثم طرح المحاور جمال الشحي سؤالاً: هل للمقال الإماراتي هوية لغوية تختلف عن المقال العربي؟
أجابت الدكتورة مريم الهاشمي: “من الضروري أن نقف على تاريخ المقال العربي أو الغربي. في الإمارات، تم تقديم هذا الجنس الأدبي كثقافة عامة في البلد. إنه يبدأ عن طريق التأمل في المجتمع والذات، كان يُعبّر عنه أولاً بالرسم، ثم تطور إلى أن ظهرت الملاحم، من أجل التعبير عن القضايا الإنسانية. كان المقال يأخذ أشكالاً أولية في التاريخ الإنساني، مثل (كتاب الشخصيات) و(كتاب الأخلاقيات). كان للحضارة الشرقية والثقافات الهندية والصينية دور في صبغ هذا النوع بطابع الحكمة والوعظ، ومثال على ذلك (اعترافات القديس أوغسطين) في بريطانيا وفرنسا. ظهور هذا الفن [بشكله الحديث] كان عن طريق الترجمة”.
وأضافت: “كان للحاضرة العربية بذور المقال في رسائل الجاحظ وإخوان الصفا وأبو حيّان التوحيدي، لكن الشكل الجديد جاء من الغرب منذ عشرينيات القرن الماضي، قبل أن تأتي المطابع إلى الواقع الخليجي. وهذا أثّر على المجتمع الإماراتي مع ظهور الآداب والروايات والقصص، وعلى الخصوص في مصر والبحرين، وبدأ الإماراتيون يراسلون تلك الصحف والمجلات. في الإمارات، كان الموضوع يتركز حول الهوية اللغوية، والاحتكاك المباشر من خلال المقالات الاجتماعية، وقد تميز الكاتب الإماراتي بصدق التعبير عن قضاياه الساخنة”.

طرح المحاور: ما هو اختلاف المقال الإماراتي عن المقالات العربية الأخرى أو ما الذي يميّزه؟
أجابت د. مريم الهاشمي: “كانت المقالات التي يكتبها الإماراتيون تهم قضايا المجتمع الإماراتي، وهي انعكاس للواقع الذي يعيشه”.
هل تسهم جائزة المقال في تطوير الصحافة؟
أجاب علي عبيد الهاملي: “لا بد من التركيز على تقنيات كتابة المقال أولاً من حيث المدخل والمتن والختام. هذه القواعد من شأنها أن ترفع من مستوى المقال وتقويه. كانت موضوعاتنا تصبّ في قضايا الوحدة والاتحاد لأننا كنا نواجه تلك المرحلة من تاريخنا. كما طُرحت موضوعات المرأة ودورها في منتصف السبعينات والثمانينات، ثم ظهرت في التسعينات قضايا الاستدامة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وطبعاً، قضية فلسطين كموضوع مركزي، والتخلص من الاستعمار”.
طرح المحاور قضية تغيير أنماط القراءة:
أجابت د. مريم الهاشمي: “الكاتب يبحث عن جمهوره، وهو بالخبرة يتمكن من تطوير أسلوبه، فالكتابة تعلُّم، كما القراءة. التحدي هو الذكاء الاصطناعي؛ هل يُستغنى به عن موهبة الكاتب وبراعته؟ هل يستطيع أن يحل محل الكاتب المبدع؟ لقد أصبح لكل كاتب صحيفته، يستطيع أن ينشر فيها ما يشاء، وهي وسائل التواصل الاجتماعي التي كسرت القيود”.
التحدي هو: مَن يقرأ لك؟
أجابت د. مريم الهاشمي: “لا بد للكاتب أن يكتب في موضوع محدد، يمتلك اللغة والسلاسة في التعبير ليتمكن من الوصول إلى قلب القارئ. ويجب أن يتمتع بالموضوعية، ويمتلك ثقافة موسوعية، وله اطلاع في علم الاجتماع والفلسفة والأدب. الكتابة مسؤولية كبرى، وللمقال أهمية في توجيه القارئ للقراءة. المجتمع الثقافي لا يشكل سوى 20 بالمئة، والمفكرون قلة، وكذلك كتّاب المقال، فهم أحياناً على عدد الأصابع، أقصد البارزين منهم”.
وطرح المحاور سؤالاً آخر: هل يقرأ العرب للكتّاب الإماراتيين؟
أجاب علي عبيد الهاملي: “لا يقل الكاتب الإماراتي عن أي كاتب عربي يستحق قراءة مقالته. لكن انتشار الكاتب الإماراتي كان محصوراً. لا يعني أن يكتب الكاتب في صحيفة (الشرق الأوسط) أو (النهار) لكي يشتهر. أنا أكتب في صحيفة (البيان) وهي منتشرة على الإنترنت، وتأتيني ردود أفعال على مقالاتي من أنحاء العالم، ومن الصين بالذات. البضاعة الجيدة تفرض نفسها. التقنيات الحديثة كسّرت الحواجز، ولدينا كتّاب إماراتيون يكتبون في (الـ سي. إن. إن.) مثل د. عبد الخالق عبد الله”.
ثم أضاف: “إن المثقف الإماراتي يريد المثالية إذا أراد أن يفعل شيئاً. هذه سمة تجعل الكاتب الإماراتي يثق بنفسه”.
وهل تعتبر جائزة المقال الإماراتي تكريماً أم لها أبعاد رمزية؟
أشار الهاملي إلى أن “الجوائز لها تأثير تحفيزي، وهناك جوائز عديدة في هذا المجال مثل جائزة تريم عمران، وجائزة الصحافة العربية”.
وقالت د. مريم الهاشمي: “البيئة الإماراتية مشجعة من خلال توفر الجوائز وتنامي دور النشر ومعارض الكتب وغيرها من الثراء الثقافي في هذا الحراك، والمقالة تثري الفكر. وتواجه الصحافة الثقافية تحدياً كبيراً أمام وسائل التواصل الاجتماعي”.

مداخلات الحضور
وتدخل الأستاذ بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، قائلاً إن الكتب تعاني من الكساد بسبب انحسار القراءة. وأضاف: “لقد سألت ذات مرة أحد الناشرين، وهو قارئ جيد وصاحب مطبعة، هاشم الهاشمي، فيما لو يزمع إعادة طباعة كتاب سالم بن علي العويس. ومن المعروف أن أول كتاب في الإمارات طُبع على نفقة الشيخ مكتوم، والثاني طُبع على نفقة الشيخ حمدان. لم تكن هناك رؤوس أموال مخصصة للطباعة، بحيث كان البعض يطبع في الهند مثل سعيد المدفع. لا شك أن قيام الاتحاد دفع بعملية النشر والطباعة إلى الأمام. وإنني بصدد تحضير ورقة عن الإصدارات في الإمارات. وهناك كتب مثل كتاب حميد بن سلطان الشامسي الذي طُبع ولم يُفسح”.
ثم تدخل الكاتب والمفكر الدكتور عبد الخالق عبد الله، متحدثاً عن “جائزة المقالة الإماراتية”: “لم نكن نتوقع النجاح الكبير الذي نالته هذه الجائزة، مما دفعنا لرفع فروعها من 6 إلى 9. وتلقينا الدعم المالي من رجل الأعمال الحبتور، وكذلك من قبل نادي دبي للصحافة. كما استحدثنا جائزة للشباب والناشئة، وكذلك لكاتب المقالة المقيم. ورفعنا من قيمة الجائزة المالية”.
قراءة نقدية في “مستقبل” المقال الإمارتي
قدمت ندوة “إطلالة على جائزة المقال الإماراتي”، التي استضافتها “مؤسسة العويس الثقافية” بحضور الأستاذ علي عبيد الهاملي والدكتورة مريم الهاشمي، مادة أرشيفية وتوثيقية مهمة لمسار المقال الصحفي في الإمارات. لكن القيمة الحقيقية لهذه الندوة لا تكمن فقط فيما قيل، بل فيما أثارته من إشكاليات جوهرية حول هوية المقال ومستقبله في عصر يتجاوز الأشكال التقليدية.
1. إشكالية “النشأة”: من التوثيق الأرشيفي إلى قياس الأثر
يطرح الأستاذ علي عبيد الهاملي مساراً تاريخياً خطياً للمقال، بدءاً من “صحافة الحائط” (1927) ومروراً بـ “أخبار دبي” (1965) وصولاً إلى صحافة الأندية في السبعينات. هذا التوثيق ضروري، لكنه يثير سؤالاً نقدياً: هل كان الاحتفاء بـ “الوجود” (وجود صحف) أم بـ “الأثر” (تأثير المقالات)؟
عندما يذكر الهاملي أن “سقف التعبير كان عالياً ولا حدود له” في تلك الفترة، يظل هذا “السقف” بحاجة إلى تحديد. ما هي القضايا الجدلية التي اشتبك معها المقال الإماراتي في السبعينات والثمانينات؟ إن السرد التاريخي يميل أحياناً إلى “أرشفة” البدايات، دون الغوص في مدى “نقدية” تلك البدايات أو أثرها الفعلي في تشكيل الوعي العام. لقد ركز السرد على “متى بدأنا” أكثر من “ماذا قلنا”.
2. إشكالية “الهوية”: تجاوز “صدق التعبير” إلى “البصمة” الأسلوبية
عند طرح سؤال “الهوية اللغوية”، تقدم الدكتورة مريم الهاشمي إجابة تربط المقال بجذوره الفلسفية (الجاحظ، أوغسطين) وتنتهي ببراعة إلى أن الكاتب الإماراتي “تميز بصدق التعبير عن قضاياه الساخنة” و”انعكاس للواقع”.
نقدياً، هذا التوصيف، وإن كان صحيحاً، لا يكفي لبلورة “هوية”. فـ “صدق التعبير” و”انعكاس الواقع” هما شرطا الكتابة الجيدة في أي مكان، وليسا هوية خاصة. السؤال الذي ظل معلقاً هو: ما هي السمات الفنية أو البنيوية للمقال الإماراتي؟
هل هو مقال “براغماتي” يميل لتقديم الحلول (كما هي طبيعة الدولة)؟
هل هو مقال “استشرافي” يركز على المستقبل (الاستدامة، التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي) أكثر من نبش الماضي؟
أم هو مقال “توفيقي” يميل إلى بناء الإجماع وتجنب الصدام كقيمة ثقافية؟
يبدو أن المقال الإماراتي لا يزال يبحث عن “بصمته” الأسلوبية التي تميزه عن المقال العربي، وهو ما لم تحسمه إجابات الندوة.
3. إشكالية “التحدي”: من “القارئ” إلى “المنصة”
كان محور “تحديات القراءة” هو الأكثر كشفاً عن الفجوة بين “المقال التقليدي” و”الواقع الرقمي”. تتساءل الدكتورة مريم الهاشمي: “التحدي هو: مَن يقرأ لك؟”، بينما يرى الأستاذ الهاملي أن “البضاعة الجيدة تفرض نفسها” ويستشهد بردود الفعل على مقالاته في “البيان” عبر الإنترنت.
هنا يكمن سوء فهم لطبيعة التحدي. فالمشكلة ليست في “انحسار القراءة” بل في “تغير نمطها”.
التحدي ليس القارئ، بل المنصة: لم يعد المقال هو “العمود” الثابت في الجريدة. المقال اليوم هو “ثريد” (Thread) عميق على منصة X، أو “مقالة” (Pulse) تحليلية على LinkedIn، أو “نص مرافق” لفيديو على تيك توك.
التحدي ليس الذكاء الاصطناعي كـ “بديل”: خوف الدكتورة مريم من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل “الكاتب المبدع” هو خوف مشروع، لكن التحدي الأعمق هو كيف سيستخدم الكاتب هذا الذكاء كأداة لإنتاج “عمق” وليس “غثاء”؟
التحدي ليس “غياب الصحيفة”: قولها إن “لكل كاتب صحيفته” (وسائل التواصل) صحيح، لكن هذه “الصحف” كسرت “القيود” (كما ذكرت) ولكنها كسرت أيضاً “الشكل” التقليدي للمقال.
إن التمسك بالثالوث الأكاديمي (مدخل، متن، ختام) الذي ذكره الهاملي، والاعتماد على “جودة البضاعة” وانتظار القارئ، هو أشبه بانتظار “راكب” في محطة قطارات مهجورة، بينما انتقل “الركاب” كلهم إلى المطار.
4. إشكالية “الجائزة”: التحفيز أم “التقنين”؟
تأتي “جائزة المقال الإماراتي” (كما أوضح الدكتور عبد الخالق عبد الله) كقوة دفع مهمة، تتوسع من 6 إلى 9 فئات وتلقى دعماً مالياً سخياً. الجوائز، كما ذكر الهاملي، “تحفيزية”.
لكن نقدياً، الجوائز قد تتحول من “محفز” إلى “مُقنّن”. أي أنها تكرّس وتشرعن الشكل التقليدي للمقال الذي تعرفه لجان التحكيم.
هل تكافئ الجائزة المقالات “الأكثر انضباطاً” أم “الأكثر جرأة”؟
هل ستخصص فئات (من ضمن التسع) للمقال الرقمي، أو “البودكاست” التحليلي (وهو مقال مسموع)، أو “صانع المحتوى” الفكري؟
أم أنها ستركز على “تقنيات كتابة المقال” الكلاسيكية، وتساهم، دون قصد، في تحنيط فن يُفترض فيه أن يكون “ابن يومه”؟
خاتمة: تجاوز “جودة البضاعة” إلى “ابتكار الشكل”
ولعل جوهر ما قدمته “مؤسسة العويس” هو إطلالة ممتازة على تاريخ المقال الإماراتي، لكنها تقف على عتبة مستقبله بحذر. إن فن المقال يتطور بسرعة، والتحدي الحقيقي للصحافة الإماراتية ولكتّابها ليس فقط في “جودة البضاعة” التي “تفرض نفسها” كما قال الهاملي، بل في فهم “السوق” الجديد وتغيير “شكل البضاعة” لتناسبه، دون التنازل عن عمقها.
إن الندوة، والجائزة، تضعان الكاتب الإماراتي أمام مسؤولية تاريخية: إما أن يبقى “كاتب عمود” في صحيفة (ورقية أو إلكترونية)، أو أن يصبح “مفكراً” يطوّع أدوات العصر لتقديم مقال إماراتي يليق بمستقبل هذا العصر.