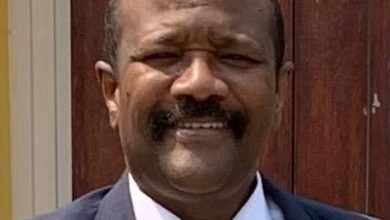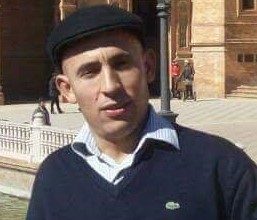تقاطع العقيدتين الإسرائيلية والإيرانية – صراع مشاريع على حساب العرب

تقاطع العقيدتين الإسرائيلية والإيرانية – صراع مشاريع على حساب العرب
أ. معتز فخرالدين
بعد أن استعرضنا في المقالين السابقين عقيدة المحيط الإسرائيلية وعقيدة تصدير الثورة الإيرانية، نصل إلى مقارنة تكشف مسارات التشابه والاختلاف، وعن كيفية تداخلهما في تشكيل مشهد إقليمي مأزوم.
منطلق كل مشروع مختلف جوهرياً:
إسرائيل انطلقت من عقدة الخوف من المحيط العربي، شعور الدولة الصغيرة بالحصار والتطويق من قبل دول عربية قوية، فكان هدفها الأول تأمين البقاء والأمن القومي عبر تحالفات خارجية واستغلال الانقسامات الداخلية.
إيران انطلقت من عقدة أيديولوجية–عقائدية بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، ساعية إلى تثبيت النظام داخلياً وتوسيع نفوذها الإقليمي عبر تصدير الثورة والمذهب، أي تحويل إيران إلى مركز قيادة إقليمية وفق رؤية “ولاية الفقيه”، بغض النظر عن شعور بالخطر المحيط.
أولًا: منطلقات العقيدتين
إسرائيل: دولة صغيرة في محيط معادٍ، فكان الحل هو بناء شبكة تحالفات مع دول وأقليات غير عربية لتفكيك أي جبهة عربية موحدة.
إيران: مشروع يدمج بين البعد العقائدي–المذهبي والاستراتيجي–السياسي لتوسيع النفوذ والسيطرة الإقليمية.
ثانيًا: أدوات التنفيذ
الأداة الإسرائيلية:
في النسخة المعاصرة من عقيدة المحيط، تركز إسرائيل على تحالفات مع دول جديدة على المحيط الإقليمي مثل أذربيجان، اليونان، وقبرص، مع الاستمرار في استثمار الانقسامات الداخلية للدول العربية.
لم تعد إيران وتركيا وإثيوبيا جزءاً من هذا الإطار الاستراتيجي المباشر كما في النسخة القديمة، ما يعكس التكيف مع الواقع الجيوسياسي الحديث.
التحالفات مع الأقليات (الأكراد، مسيحيون، دروز…) مستمرة، لكنها تعمل ضمن النسخة الحديثة من الاستراتيجية.
الأداة الإيرانية: إنشاء ميليشيات عقائدية عابرة للحدود (حزب الله، الحشد الشعبي، الحوثيون…) مرتبطة مباشرة بمبدأ “ولاية الفقيه”، ودعم أحزاب وشخصيات سياسية موالية في الدول العربية.
الأبعاد الاقتصادية للنفوذ الإيراني
إلى جانب الأبعاد العسكرية والسياسية، تستخدم إيران النفوذ الاقتصادي لتعزيز مواقعها في الدول العربية، من خلال تقديم الدعم المالي للميليشيات المحلية، تمويل المشاريع الاقتصادية في مناطق النفوذ، والاستثمار في البنى التحتية والمبادرات الاجتماعية التي تخلق بيئة مؤيدة للمشروع الإيراني. هذا البعد الاقتصادي يعزز من استمرارية النفوذ ويكمل الأدوات العسكرية والسياسية.
ثالثاً: نقاط التشابه
1. الرهان على الانقسامات الداخلية: كلا المشروعين رأى في التعددية العرقية والمذهبية في المنطقة فرصة لاختراق الدول.
2. إضعاف الدولة الوطنية العربية: سواء عبر دعم حركات انفصالية (إسرائيل) أو عبر الميليشيات الموازية للدولة (إيران).
3. البعد الفلسطيني: إسرائيل عملت على تفكيك الدعم العربي لفلسطين، وإيران رفعت شعار “القدس” لكنه وظف كورقة نفوذ لا كمشروع تحرري فعلي.
رابعاً: نقاط الاختلاف
1. طبيعة الخطاب:
إسرائيل: خطاب أمني–براغماتي (تحالفات مصلحية).
إيران: خطاب أيديولوجي–عقائدي (الثورة، المقاومة، المظلومية).
2. أدوات السيطرة:
إسرائيل: استخبارات، دعم عسكري محدود، تحالفات سياسية، مع ضبط التحالفات وفق الواقع المعاصر.
إيران: ميليشيات مسلحة، أذرع اقتصادية مذهبية، خطاب تعبوي مستمر.
3. مدى الشرعية:
إسرائيل مكشوفة العداء عربياً، ومشروعها يُرى خارجياً استعمارياً.
إيران استطاعت أن تتخفى خلف شعارات ‘المقاومة’ لكسب شرعية في الشارع العربي، رغم أن ممارساتها غالباً تصب في تفتيت الدول.
خامساً: فلسطين بين التوظيف والتغييب
فلسطين تكشف التناقض–التقاطع بين العقيدتين:
إسرائيل جعلت من تحييد القضية الفلسطينية أو تفريغها من بعدها العربي–التحرري غاية استراتيجية لعقيدة المحيط إذ أن إضعاف العمق العربي يضمن تحويل فلسطين من قضية جامعة إلى ملف تفاوضي ثانوي.
إيران رفعت شعار ‘القدس’ و’المقاومة’ لتبرير مشروعها الإقليمي، لكن توظيفها كان وظيفياً وانتقائياً: القضية تحوّلت إلى ورقة شرعية تُستخدم لحشد الأتباع وكسب النفوذ، لا لتحرير فلسطين فعلياً.
هكذا، التقت العقيدتان في ضرب الطابع العربي التحرّري للقضية، وتحويلها إما إلى عبء تفاوضي أو راية أيديولوجية، بينما ضاع جوهرها كقضية تحرر وطني.
سادساً: في السياق السوري واللبناني
سوريا: التقت مصالح إسرائيل (إضعاف الدولة المركزية) مع مصالح إيران (تمكين الميليشيات الطائفية)، دون تنسيق مباشر.
لبنان: إيران عبر حزب الله سيطرت على قرار الدولة، فيما استفادت إسرائيل من الانقسام لتكريس صورة لبنان كدولة فاشلة وعاجزة.
خاتمة
تُظهر المقارنة بين عقيدة المحيط الإسرائيلية وعقيدة تصدير الثورة الإيرانية أن المشروعين يلتقيان في تفكيك الهوية العربية وتفريغ الدولة الوطنية من مضمونها، وإن اختلفت الخطابات والأدوات. إسرائيل تتحرك ببراغماتية باردة عبر تحالفات مصالح، وإيران تتحرك بخطاب أيديولوجي عاطفي عبر ميليشيات مذهبية. والنتيجة واحدة: دول عربية مفككة، مجتمعات ممزقة، وغياب مشروع عربي جامع.
إدراك هذا التشابك ليس تمريناً أكاديمياً فقط، بل دعوة إلى بلورة مشروع عربي تحرّري مضاد، يقوم على إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، وتحصين الهوية الجامعة، وتحرير القرار السياسي من ارتهان المشاريع الخارجية. من دون ذلك سنظل عالقين في لعبة محاور تستنزفنا وتعيد إنتاج أزماتنا بلا أفق